عرض لكتاب مصير السودان: نتائج وجذور عملية السلام الناقصة
بقلم جون يونق
26 فبراير 2013 – عاش مؤلف الكتاب جون يونق في منطقة القرن الأفريقي وتنقل بين دولها منذ العام 1986 حيث عمل باحثا في ميادين السلام والأمن، الحكم، الفيدرالية والصراعات والأحزاب السياسية وذلك من خلال مختلف المواقع التي عمل بها صحافيا وباحثا أكاديميا وخبيرا لدى الحكومة الكندية وأحد مراقبي عملية السلام في السودان ومستشارا سياسيا لدى مركز كارتر خلال فترتي الأنتخابات وأستفتاء الجنوب على حق تقرير المصير.
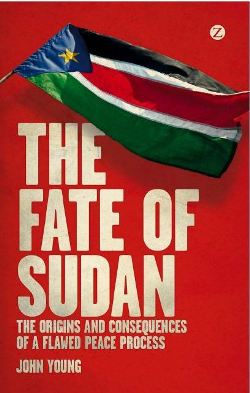 يقول المؤلف ان تجربة السودان مع عملية السلام ليست متفردة، وأنما معدة ومدفوعة بواسطة المجتمع الدولي وتعتمد على أساس نظري ضعيف. ونقطة البداية تتمثل في دفع الجهات المتحاربة الى التوصل الى اتفاق عبر وسائل سلمية ونقل الصراع عبر جهد ديبلوماسي ليكون حوارا غير متسم بالعنف حيث يمكن حسم الخلافات عبر مؤسسات ذات صفة تمثيلية. أما مرحلة بناء السلام فتعرف على أساس انها نشاط ما بعد الصراع لدعم الهياكل التي ستعمل في نهاية الأمر على تقوية السلام ومنع تجدد الصراع والعنف.
يقول المؤلف ان تجربة السودان مع عملية السلام ليست متفردة، وأنما معدة ومدفوعة بواسطة المجتمع الدولي وتعتمد على أساس نظري ضعيف. ونقطة البداية تتمثل في دفع الجهات المتحاربة الى التوصل الى اتفاق عبر وسائل سلمية ونقل الصراع عبر جهد ديبلوماسي ليكون حوارا غير متسم بالعنف حيث يمكن حسم الخلافات عبر مؤسسات ذات صفة تمثيلية. أما مرحلة بناء السلام فتعرف على أساس انها نشاط ما بعد الصراع لدعم الهياكل التي ستعمل في نهاية الأمر على تقوية السلام ومنع تجدد الصراع والعنف.
عمليات بناء السلام شهدت تطورات عكست المتغيرات التي شهدتها الساحة الدولية سياسيا واقتصاديا. وبنهاية فترة الحرب الباردة، فأن بناء السلام أقتبس من أفكار نهاية التاريخ لهنتنغتون وأصبحت مرجعيته ونقطة انطلاقه العالم الأول وكيفية التشبه بالأقتصادات الغربية ووسائل عملها السياسية. وعملية السلام في السودان لم تحقق سلاما ولم تؤمن الهدف المركزي في سودان موحد، وذلك رغم المشاركة الدولية مما يشير الى بعض الفرضيات ان مثل هذه المشاركة تعقد الصراعات في واقع الأمر، كما ان بعض التجارب في القرن الأفريقي تربط بين التقدم العسكري وتحقيق سلام مستقر وذلك لنجاحها في تحقيق نصر عسكري وتجييش مواطنيها واقامتها مؤسسات فاعلة لتأطير مختلف الأنشطة المجتمعية، وبالتالي لم يكن هناك دور يذكر للمجتمع الدولي. وعلى عكس هذه فأن الحركة الشعبية لم تستطع هزيمة خصومها عسكريا، ولم تتمتع بأي فلسفة تحررية، كما انها لم تستطع تجييش مواطنيها أو تطوير مؤسسات لتقديم الخدمات وذلك لتركيزها وأهتمامها بالجانب العسكري. وبسبب نقاط الضعف هذه كان بأمكان المجموعة الدولية لعب دور أكثر أهمية في عملية السلام السودانية.
وهو يرى ان الصراعات التي شهدها السودان كانت تركز بأستمرار على جهاز الدولة، ولم تتغير هذه النظرة خلال المفاوضات التي تكللت بأبرام أتفاقية السلام الشامل. أحد النقاط الأساسية في الكتاب انه يركز على هذه النقطة ومحورية جهاز الدولة ويرجع فشل عملية السلام في السودان الى ان التنظير الليبرالي الذي تجاهل أهمية القيام بتغييرات هيكلية في جهاز الدولة، وهي الشرط الأساسي للوصول الى السلام المستدام والديمقراطية.
عند الأستقلال كان السودان يتميز بوجود ثروة تتركز في أيدي القلة وأنتشار للفقر بين أغلبية السكان، كما تميز بوجود منافسة حامية على الموارد في أجواء من الندرة، الأمر الذي أعطى لجهاز الدولة مكانة أساسية كونه يسيطر على وسائل الأنتاج والتوزيع الى جانب الموارد. وعليه أصبح التواصل مع جهاز الدولة مهما حتى يمكن التأثير على رفاهية السكان. لكن الوصول والتواصل مع جهاز الدولة لم يكن متاحا لكل السكان بذات الطريقة، بل لم يكن متاحا للبعض بصورة كاملة. وأدى هذا بدوره الى نشوء صراعات ذات بعد أثني تطور الى صراعات مسلحة عندما لم تنجح في تحقيق أي تقدم يذكر. على ان الطبيعة الأثنية للصراع لم تنبع من منطلقات قبلية، وأنما كانت رد فعل على القوى المسيطرة على جهاز الدولة وهي مجموعات نيلية وأستخدامها للدولة لصالحها. وأستمر هذا الوضع على حاله بغض النظر عن الطبيعة الأيدولوجية للحكم القائم. وبأستثناء الفترة المبكرة من نظام النميري، فأن كل الحكومات المتعاقبة كانت تلجأ الى تقنين عملية سيطرتها وأعطاءها شرعية من خلال التأكيد على هوية البلاد العربية والأسلامية. وهذه الهوية لم تكن تعني شيئا للجنوبيين الذين كانوا أول من ثار ضدها، ولن يكونوا الأخيرين.
رغم ان كلا من الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني يقفان على طرفي نقيض أيدولوجيا، الا ان بينهما بعض الخصائص المشتركة مثل: الولاء القوي لقضيتهما والأحتقار لكل من لا يشاركهما رؤيتهما تلك وللنهج الديمقراطي عموما، تركيزهما الأساسي على السلطة وعدم ترددهما في اللجوء الى العنف لتحقيق أهدافهما، كما ان الحزبين يهيمن عليهما قيادات ذكية وذات كارزيما تم رفضهما من قبل أعضاء أحزابهما في نهاية الأمر. فسقوط الترابي جاء بعد محاولته الأنقلاب على البشير، لكن لم يختف من المسرح وأنما ظل يشكل هاجسا وتهديدا سياسيا وأمنيا لحكومة المؤتمر الوطني، وذهب خطوة في تحدي خصومه بتوقيعه لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية، الأمر الذي دفع الحكومة الى أعتقاله لأنها تتخوف من بروز تحالف بين الحركة الشعبية والمعارضة الشمالية. لكن لتلك المذكرة أهميتها الأخرى المتمثلة في انه اذا أستطاع زعيم اسلامي التوصل الى أتفاق مع قرنق، فلماذا لا يتوصل المؤتمر الوطني الى أتفاق مع الحركة الشعبية.
وبالنسبة لقرنق فأن تلك الخطوة كانت بهدف اضعاف خصومه وقام بها منفردا وكما يقول المؤلف فأن سلفا كير أخبره أنه لم يعرف بمذكرة التفاهم بين الحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي الا من وسائل الأعلام كما طلب نسخة من المذكرة من المؤلف للأطلاع عليها. قرنق من جانبه كان يواجه معارضة متزايدة في صفوف حزبه الذين كادوا ينقلبون عليه قبل أقل من عام على وفاته وذلك بسبب عدم رضاءهم على الطريقة التي يدير بها الحركة، لكن قرنق نجح في أحتواء تلك المواجهات لأن رفاقه معتمدون عليه ولم يكن سهلا الأتفاق على بديل الى جانب التخوف من حدوث أنشقاق عشية توقيع أتفاق السلام. ولهذا عاد قرنق الى ممارساته السابقة بعد أنتهاء المواجهة في ياي. فالرجل الذي لم يكن قادرا على القيام بمصالحات والقضاء على التناقضات داخل الحركة لم يكن قادرا على الأنجاز رغم أعطاءه الأنطباع بعكس ذلك. ولهذا فهو قد ترك الحركة وجنوب السودان معتمدان على المجتمع الدولي، كما ان رؤيته عن السودان الجديد دفنت معه بعد مقتله وبقي بعده فقط النزعة العسكرية والسلطوية الى جانب ضعف مؤسسي لدى الحركة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات يقول المؤلف أيضا انه رغم الدعم الكبير الذي تلقته الحركة من الجيران في الاقليم، الا انها لم تستطع هزيمة الجيش السوداني، ولهذا ركزت على المجتمع الدولي لتحقق عبر المفاوضات ما فشلت في تحقيقه في ساحات القتال. وهذاالأعتماد على المجتمع الدولي والجيران جعل الحركة عرضة للضغط. ويقول المؤلف ان قرنق لم يكن متحمسا للقاء علي عثمان بداية لدرجة انالأخير انتظره في نيروبي، الأمر الذي دفع وزير الخارجية الكيني وقتها كالونزو مسيوكا الى استدعاء ممثل الحركة في كينيا الدكتور جستن ياك وانذاره ان قرنق اذا لم يحضر للأجتماع والالتقاء بعلي عثمان فعلي الحركة أن تغلق مكاتبها وتغادر كينيا.
من جانبه فأن المؤتمر الوطني الذي يعاني من عزلة على الساحة الدولية سعى للخروج من المفاوضات بأقل قدر ممكن من الخسائر، كما انه لم يكن في وارد رفض وساطة الأيقاد المدعومة من الولايات المتحدة خوفا من يتعرض الى ضربة عسكرية أمريكية أو دفعها مساندة الحركة بصورة أقوى. وكل ما كان يطلبه المؤتمر الوطني عملية سلام تركز على علاقات الشمال والجنوب، و لا تشمل بقية القوى الأخرى المعارضة أو منظمات المجتمع المدني كي لا تتحالف مع الحركة و تهدد وضع الشريعة، وهو ما كان سهلا على الوسطاء الدوليين و الحركة الاستجابة له. ولهذا فالقضايا المعقدة مثل التحول الديمقراطي أو وحدة السودان فقد تم تأجيلها الى مراحل لاحقة، ولم يختلف منطق الحركة وحساباتها كثيرا عن تلك الخاصة بالمؤتمر الوطني. قرنق لم يعش لير الجنوبيون يصوتون بصورة كاسحة للأنفصال وأنهاء حلمه، وعلي عثمان لا يزال ينتظر تنفيذ واشنطون وعدها رفع عقوباتها ضد السودان، كما لم يحدث التحول الديمقراطي المنشود. وبدلا من أن تكون الأتفاقية منطلقا لحلحلة مشاكل البلاد، أصبحت عبئا اضافيا لأن المشكلة الأساسية المتمثلة في اعادة هيكلة جهاز الدولة لم يتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية و الوسطاء على كيفية حلها.
وفيما يخص التحول الديمقراطي، فأن الانتخابات التي تعتبر الأداة الأساسية في هذا الجانب لم تجر بالصورة المطلوبة رغم حضور مراقبين أجانب يفترض ان يسهم حضورهم في ضمان صدقية هذه الانتخابات وذلك لأن حيدة هؤلاء المراقبين أصبح مشكوكا فيها لأنهم قرروا من البداية الا تؤدي تلك الانتخابات بأي صورة من الصور الى تعقيد أجراء استفتاء الجنوب على حق تقرير المصير.
ورغم ان الأستفتاء انجز بسلاسة الا ان الطرفين أصبحت أعينهما على القضايا العالقة وكيفية استخدام التعامل مع المستقبل عن طريق استخدام المليشيات التابعة لهما في الطرف الآخر. فبالنسبة للمؤتمر الوطني كيف يمكن اضعاف الحركة الشعبية وربما عمل انقلاب على حكومتها، بينما في جوبا كان البعض يوازن بين اتجاه يدعو الى تغيير النظام، ولم يكن خيار العيش في جوار آمن وتخطي عقلية الحروب بين الخيارات. وفي الجنوب لم تتقدم كثيرا أحاديث الوحدة الوطنية التي برزت عشية الأستفتاء، حيث اعتبرت قيادة الحركة ان نتيجة الأستفتاءكانت في جانب منها استفتاء على شعبيتها، الأمر الذي يؤذن بأتساع الشقة بينها وبين بقية الأحزاب ومن ثم المواطنين.
أما المجتمع الدولي فقد قام بتهنئة نفسه على انجاز الانفصال والحديث عن مستقبل واعد بين الدولتين الا ان الديلوماسيين الغربيين كانوا خلف الغرف المغلقة يتحدثون بقلق عن المستقبل الملىء بالمصاعب وبشىء من الصراحة عن قصور اتفاقية السلام فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي وضعف الاحزاب، بل والثناء على مرونة البشير الذي تمنعهم حكوماتهم من الالتقاء به.
ومن ناحية أخرى فقد كاد قارب عملية السلام أن يتحطم بسبب المناطق الثلاثة، التي يمكن أن تعيد الدولتين الى الحرب مجددا. فعقود من التجاهل والسياسات الخاطئة للحكومات السودانية المتعاقبة أسهمت في أشعال فتيل التمرد، الذي ردت عليه الخرطوم باللجوء الى الخيار الأسهل وهو تجييش المليشيات القبلية لقتال الحركة الشعبية، الأمر الذي دفع الصراع ليأخذ بعدا أثنيا بين عرب وأفارقة خاصة مع اصرار النخب في جانبي الصراع لأخذ الأمور في أيديهم وتكسير الأطر الأدارية التقليدية وهو التقليد الذي بدأه النميري وواصله الآخرون وبدون توفير البدائلمما يشير الى ضعف كلا من برنامجي الأسلمة والسودان الجديد في كيفية مقابلة احتياجات المواطنين الذين يدعون الحديث باسهمهم وحمل السلاح من أجلهم.
فالحركة الشعبية لم تستفد حتى من التجارب المشابهة كما في أثيوبيا القريبة التي ضمت كل الأثنيات في تنظيم سياسي عريض وسمحت لها بشىء من الحركة، لكن قرنق أصر على حزب واحد وجيش واحد لكل السودان، الأمر الذي جعل من الجيوب التي أوجدها في النيل الأزرق وجنوب كردفان نقاطا للتوتر يمكن أستغلالها لأضعاف الشمال، ولم يكن يتخيل بالطبع انه سيموت وسيخلفه من سيكون تركيزه على الجنوب فقط والانفصال. فقرنق كان ديكتاتورا لكن لديه رؤية وطريقة ما لأنفاذ تلك الرؤية. والذين خلفوه لم يروا في فكرة التحرير الا التحرر من الجلابة. فسلفا كير مثلا يتحدث عن اللغة العربية على أساس انها لغة الجلابة المستعمرين وبدون أن ينتبه الى ان الانجليزية التي يتحدث بها لغة مستعمر هي الأخرى.
أفرز أكمال الأستفتاء وانفصال الجنوب عدة قضايا من بينها حاجة السودان الى دستور جديد، الأمر الذي أبرز أهمية وجود حكومة ذات قاعدة عريضة وذلك بسبب فقدان الجنوب وتعميق الأزمة الاقتصادية واشتعال الحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. والمفارقة انه وبعد جهود استمرت سنين عديدة لاضعاف القوى الاسلامية الممثلة في الاحزاب التقليدية كالأمة والاتحادي الديمقراطي عاد المؤتمر الوطني لخطب ودها مرة أخرى. بالنسبة للجنوب فأول نتيجة كانت انتهاء حالة الوحدة الوطنية التي عاشها الجنوب عشية الاستفتاء، كما برزت توترات في الاقاليم خاصة عند الاستوائيين الذين لم ينظروا بكثير تقدير الى فترة حكم الحركة الشعبية ابان الفترة الانتقالية. ولم يكن عدم رضاهم نتيجة لهيمنة الدينكا فقط، وأنما كما يقولون بسبب هيمنة الدينكا غير المؤهلين. وقد أصر سلفا كير الى ان يحصل على سلطات أكبر تقدح في الترتيب الفيدرالي الذي طالبت به الاقاليم خاصة الاستوائية وذلك على أساس ان البلاد تدخل مرحلة حرجة وتحتاج الى تقوية الحكومة المركزية لمقابلة هذه التحديات وشملت سلطاته حتى حق اقالة الولاة المنتخبين. وهذا ما دفع جوزيف لاجو الى القول ان السلطات التي كان يحظى بها أبان الحكم المايوي أكثر من السلطات التي تتمتع بها الاقاليم تحت حكم الحركة الشعبية. وأصبح واضحا ان سلفا كير الذي عاش طوال عمره تحت ظلال قرنق، أصبح يسعى وبجد لتسلم سلطاته كذلك وبدون ان تكون لديه رؤية قرنق أو ذكاءهبل ولا حتى الأحترام وسط مختلف قطاعات الحركة الشعبية أو الجنوبيين عموما. وأعتبر الى حد كبير أداة لتحقيق الانفصال والأستغلال بواسطة الأفراد الاقوياء حوله.
أصبح جنوب السودان دولة مستقلة تعتمد على عائدات النفط، لكنها لم تسع خلال حربها التي استمرت عقدين من الزمان الى جانب ستة أعوام الفترة الانتقالية في تأسيس اقتصاد بديل واستمرت في سياسة شراء الولاء عبر التوظيف وسيلة لأنفاق اموال النفط، وللمفارقة فقد كانت هذه أحد نقاط انتقاد الحركة الشعبية لحركة الأنيانيا سابقا. ويقدر ان 77 في المائة من عائدات الدولة حاليا تذهب الى دفع المرتبات.
ومن الأوجه الأخرى لسياسة الحركة الاقتصادية تأجير أراضي الدولة للأجانب. ووفقا لدراسة لمنظمة العون الشعبي النرويجية، التي تمتع بعلاقات وثيقة مع الحركة الشعبية انه بحلول استقلال جنوب السودان كانت الحركة قد باعت 9 في المائة من أراضي الجنوب الى مستثمرين أجانب، ويقدر حجم هذه الأراضي بنحو 2.9 مليون هيكتار بيعت باسعار رمزية تصل أحيانا الى أربع بنسات للهكتار.
أما في الشمال فأن بداية العام 2011 شهدت انطلاق مظاهرات هدفت الى اقتفاء أثر ثورات الربيع العربي الهاتفة بسقوط النظام مما أدى الى الكثير من الاعتقالات بما في ذلك بعض الاطفال ، كما ترددت تقارير عن حدوث عمليات تعذيب وانتهاكات جنسية واسعة للمعتقلين بصورة لم تعرف من قبل في السودان، رغم ان المعارضة التقليدية ظلت بعيدة الى حد كبير عن هذه المظاهرات، التي ظل الطلاب والشباب هم محركوها الاساسيين. لكن على غير ما كان عليه الأمر سابقا في السودان، فأن معظم الاتحادات الطلابية يسيطر عليها عناصر من المؤتمر الوطني بسبب التوسع الكبير في التعليم والدخول الى الاقاليم وأبناءها وهي أكثر ميلا الى المحافظة، لا الثورة، بصورة عامة. ولهذا لم تعد الجامعات مراكز ثورية ضد النظام القائم. هذا الى جانب نجاح قوى الأمن في التحرك السريع وأعتقال الناشطين بل والتغلغل بينهم مما أدى الى عدم اكتساب المظاهرات الطلابية للبعد الشعبي المطلوب خاصة وطول حكم الانقاذ واضعافها للقوى المعارضة أسهمت في اضعاف الثقة في هذه المعارضة وقدراتها.
على ان من أكبر التحديات التي تواجه المؤتمر الوطني الخلافات داخله خاصة بين النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان ونائب رئيس الحزب نافع علي نافع التي اتضحت منذ توقيع اتفاق السلام، عندما انتقد نافع علي عثمان لتصديقه الوعود الأمريكية بتحسين العلاقات مع السودان نتيجة لتوقيع اتفاق السلام. ومع ان الخلاف بينهما ظل تحت السيطرة الا ان اعلان البشير رغبته في عدم الترشيح مجددا فتح باب التنافس بينهما عمن يخلفه. كذلك برز صلاح قوش رئيس جهاز الأمن السابق والذي لا يخفي طموحاته مرشحا محتملا لخلافة البشير.
انتهت عملية السلام والقضايا المعلقة بسبب الانفصال لا تزال عالقة، الأمر الذي يعيد الكرة الى الملعب الأمني وهذا ما جعل وجود قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة أمرا مهما سعى اليه الجنوب وحصل عليه وتقودها هيلدا جونسون المتعاطفة مع الحركة الشعبية التي ردت اليها الجميل وقامت بمساندة حملة تعيينها في ذلك المنصب. أما السودان فقد رفض التمديد لتلك القوات في اراضيه.
عانت منطقة القرن الأفريقي من الحروب والنزاعات أكثر من أي منطقة أخرى في أفريقيا،وأدت هذه الأوضاع المضطربة الى بروز دولتين جديدتين على الخارطة وتحظيان بأعتراف دولي هما أرتريا وجنوب السودان، الأمر الذي شكل تحديا مستمرا لمبدأ أحترام الحدود الأستعمارية الذي تواطئت عليه أفريقيا. وقبل انفصال جنوب السودان كان واضحا من التجارب السابقة خاصة أرتريا والصومال ان الانفصال لن يؤدي بالضرورة الى سلام أو أستقرار ناهيك عن أحداث تحول ديمقراطي، لكنه بالعكس فاقم من حدة النزاعات سواء بين الدول أو على المستوى القطري.
فالقاعدة العامة في القرن الأفريقي ان نخبا تستند الى خلفية أثنية تستخدم جهاز الدولة لصالحها وتخلق وحدة مزيفة للترويج لثقافتها وأيدولوجيتها وسط مواطني هذه الدول. وفي غياب بديل ديمقراطي حقيقي، فأن هذا الأتجاه ينتج بدوره معارضة قد تتطور الى حمل السلاح وتصل الى المناداة بحق تقرير المصير وتعمل على تحطيم جهاز الدولة الذي ترى انه يستهدفها. وهذا هو الأطار الذي تجري فيه الصراعات وأعمال العنف التي يشهدها السودان وجنوب السودان، حيث تقوم جوبا بمساندة المناطق الثلاثة ودارفور لأحداث تغيير للنظام في السودان. واذا فشل هذا الخيار فربما تصل الى حق تقرير المصير في اطار صراع عرب وأفارقة لتصبح دولة مستقلة أو متحدة مع الجنوب.
على ان جنوب السودان نفسه ليس بمأمن من معاملة مماثلة خاصةو القيادات التي برزت بعد الانفصال في في أرتريا وجنوب السودان سرعان ما تقمصت الأدوار التي ثارت عليها. فقيادة الحركة الشعبية عانت دائما من النخبوية والقبلية، التي أنتجت بدورها صراعات أخرى. وبأنجاز الأستقلال وفشل قيادة الحركة في أصلاح نفسها والتعامل كحكومة مسؤولة عن مواطنيها وتقديم الخدمات والتنمية لهم فأن بؤر التوتر والنزاع الحالية يمكن أن تتطور الى تهديد استراتيجي في شكل مطالبات بحق تقرير المصير لمجموعات أثنية مختلفة.
فشل الحكومات السودانية المختلفة ومتمردي الجنوب في حل نزاعات البلاد عسكريا أو سياسيا فتح الباب أمام التدخل الأجنبي، الذي لم يحقق أي نتائج أيجابية لأنه محكوم بمصالح الدول الأجنبية خاصة الولايات المتحدة التي تشغلها هموما الأمنية في المقام الأول. ولهذا لم يكن غريبا أن تركز على التعامل مع النخب في الشمال والجنوب وأعطاءها شرعية طوال فترة الأتفاقية وربما الى مابعدها وذلك على حساب احداث تحول ديمقراطي لصالح شعبي البلدين
